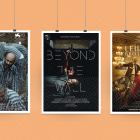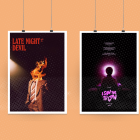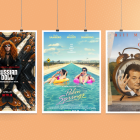فن
أهل الكهف والمعالجات السينمائية للأدب: غير ما يلزم
هل تحويل العمل الأدبي إلى سينمائي أو درامي ومعالجته في هذا الإطار كما حدث في فيلم «أهل الكهف» يفترض الالتزام التام بالنص الأصلي؟
 بوستر فيلم «أهل الكهف»
بوستر فيلم «أهل الكهف»
يبشر فيلم «أهل الكهف» ببعض من محتواه عبر البوستر المخصص للفيلم الذي يجمع كل أبطاله، وعبارة لعلها عبرة الظاهرة بوضوح لا تكاد تتبين مغزاها إلا بعد بداية الفيلم.
يشير الأفيش أيضًا إلى أن الفيلم مقتبس عن مسرحية «أهل الكهف» لتوفيق الحكيم، بعد معالجة درامية بقلم أيمن بهجت قمر، معالجة لم تتخلص تمامًا من المباشرة والصوت الخطابي المميز للمسرح التقليدي، فكما يقف الممثل على المسرح مواجهًا جمهوره رافعًا عقيرته ليسمعه آخر من بالصف، مبالغًا بالدراما منتظر التحية (السوكسيه) بعد كل خطبة عصماء أو مشهد مدر للدموع، هكذا تصرف أبطال فيلم «أهل الكهف» بين المشاهد المتتابعة والإيقاع غير المتوازن بينها.
تجري أحداث الفيلم في عهد الإمبراطور دقيادنوس المعادي للمسيحية ويكسب الفيلم الأبطال نفس الديانة، وذلك بما أن صناع الفيلم قد أخبرونا بالفعل أن الفيلم مقتبس من مسرحية الحكيم، فعليه نعلم أن الرواية المعتمد عليها في الحكي عن أصحاب الكهف هي الرواية الإسلامية المذكورة في القرآن الكريم، فيما تشير حكايات التاريخ المتناقضة في تفاصيلها عن نسخة مختلفة لا تمنح أصحاب الكهف ديانة محددة، وإنما تؤكد أنهم فتية مؤمنون معادون للوثنية احتموا بالكهف هربًا من بطش الحاكم ولم يعاصروا ظهور السيد المسيح من الأصل.
المعالجة الدرامية وأبطال بلا داعٍ
يبدأ الفيلم ببعض من مشاهد الساحة الرومانية التي يتقاتل فيها المحاربون أو يطعم بعضهم للأسود تسلية أو عقابًا، مشاهد جديدة في طريقة تنفيذها ومحتواها بشكل ما على السينما المصرية، بل إن تنفيذها جاء جيدًا على نحو كبير، فلم تكن مجرد تقليد لنفس المشاهد المتكررة بالطبع في السينما الغربية، بداية تأسيسية معقولة تدفع بسؤال ما علاقة أهل الكهف بما نرى، ذلك أن هذا الجزء دخيل على مسرحية الحكيم التي تبدأ بخروج الفتية من الكهف بعد طول رقاد.
نتعرف بعد فترة بالأبطال وتبدأ المعالجة في الترهل بإضافة أبطال بلا داعٍ، ففيما نجد معلم المسيحية العجوز الذي كأنما وضع في الفيلم ليكمل الأداء الخطابي والجمل البراقة الواعظة، صوت الضمير المحذر من الهلاك، وابنته التي تلد طفلًا صغيرًا يكبر خارج الكهف لنكتشف في نهاية الفيلم أنه هو من يحكي لنا الحكاية! مشاهد ومشاهد بلا داع، لو حذف الدور ما خل بالبناء ولا الحكاية لأجل أن نبرر أو نجد من يحكي لنا الحكاية.
وكذلك تظهر شخصية التوأم نور ونار، الشخصيات الدخيلة أيضًا على القصة بأسمائهم الموحية، فالأول هو المؤمن الهادئ المطمئن الملائكي، والثاني هو المتمرد المشاغب الدنيوي القريب من الأرض، ولتتخيل الحوار الدائم بينهما بمضمون متكرر في مشاهد عديدة متكررة، وكأنهما صوت الضمير والوسواس، حكاية تقليدية تصلح لطلبة المدارس أكثر منها داخل فيلم بهذا الكم من الأبطال بالموازنة التي تحدث عنها صناعه.
ناهيك بـيمليخا الراعي الحكيم في النص الذي وضعته المعالجة في الفيلم بدور البهلوان للتخفيف من وطأة ثقل القصة والدراما، تدخل يمليخا أحمد عيد في المشاهد بخفة دمه الواضحة التي عرفناها عنه طويلًا، قبل عودته الأخيرة في بعض الأدوار الجادة، فانتزع ضحكات وضحكات أضافت له وأساءت لإيقاع دوره على طول السيناريو، فإن كان أول من وعى حقيقة استيقاظ أهل الكهف بعد مئات السنين ورغبته في العودة للكهف خوفًا من الزمن الذي تغير في الظاهر لكن البطش والظلم لا يزالان يرعيان في البلاد، وإن كان أول من صرخ في أصدقائه بضرورة فهم الدرس من المعجزة، بدت صرخات البهلوان الحكيمة، بنفس النبرة التي تلقي النكات باهتة، فلم يحفظ له المعالج الدرامي دوره شديد الحكمة، كشعاع النور في الرواية الأصلية، ولا تركه على نفس الخط الساخر فارتبكت الشخصية على الشاشة.
ونأتي للدور الأسوأ البطلة بريسكا التي قامت به غادة عادل التي ربما رأى صناع الفيلم أنها الأنسب بملامحها ولون بشرتها لأداء دور بريسكا، لكن عمرها الواضح عليها في الملامح والصوت وحتى الحركة، أساء تمامًا للشخصية حتى إن المبارزة المزعجة قرب نهاية الفيلم التي بدت أشبه برقصة أتت مبتذلة ومفتعلة وبطيئة في ردود الفعل.
المعالجات السينمائية للأدب: تجارب سابقة
بقدر ما يرتبط القارئ بالنص الأصلي للرواية أو للمسرحية أو لصنوف الأدب عمومًا، لكن تحويلها إلى عمل سينمائي أو درامي ومعالجتها في هذا الإطار لا تفترض الالتزام التام بالنص، فالمعالج مبدع أيضًا شرط أن يكون لتدخله هدف أصيل أو أن يفلح في إبرازه وتضفيره داخل العمل، أو حتى ولأسباب يراها صناعة منطقية مع مراعاة نفس الشرط أن تخلق من النص إبداعًا موازيًا، وأن تحبكه كما يقول اللفظ الشعبي الذي يمكن أن نعيد أصله إلى رسم الحبكة الدرامية وتمام شروطها.
السقا مات

مشهد من فيلم «السقا مات»
تحكي رواية «السقا مات» ليوسف السباعي قصة شعبية اجتماعية ساخرة فلسفية عن الموت، وعلى الرغم من قتامة الفكرة أو الهدف تأتي الرواية في نص ضاحك ساخر ممتع وبديع يجعلك تتجاوز نهايتها المقبضة والمتممة لحكمة الرواية بموت السقا، التي يشير إليها النص في الأساس من العنوان وحتى الأغنية الساخرة من الصبي بطل الحكاية ابن السقا:
أبوك السقا مات
بيمشي في الجنازات
هيحصل الأموات
في عام 1977 أنتج فيلم مقتبس عن الرواية يحمل نفس الاسم، وعلى الرغم من أن مخرجه هو صلاح أبوسيف الذي اشتهر بلقب مخرج الواقعية، فإن قصة الفيلم ومعالجته تغيرت في كثير من مضمونها عن الرواية، فقد رأى صانعوه أن تقديم فيلم عن الموت أمر مقبض للغاية أو على أقل تقدير لن يكون مغريًا لجمهور السينما بما يكفي لمشاهدته، وهكذا تم تغيير السيناريو ليتضمن مشاهد تجمع البطل شحاتة بفتاة الليل في لقطات متخيلة لم يكن لها أصل في الرواية، وكذا التلميح ببداية قصة حب بين المعلم شوشة وابنة جاره الشابة، ليخفف من موضوع الفيلم المأساوي، ولهذا تحديدًا غيروا نهاية الرواية، فالسقا في الفيلم لم يمت.
وإذ تسيء فكرة قصة حب المعلم شوشة لابنة جاره لموضوع الفيلم الذي بُني أصلًا على وفاء السقا لزوجته الراحلة، سرعان ما يتراجع المعلم شوشة بعد سماع خبر خطبة جارته الشابة ويذكر نفسه بنفسه بعمره ووفائه لحبه القديم، وهنا نجد أن السيناريو يصلح بنفسه من عيوب إضافاته أو تغييراته في المعالجة بنفسه ليحافظ على الإيقاع.
دعاء الكروان

صورة من فيلم «دعاء الكروان»:
وفي مثال آخر على المعالجات والتغييرات السينمائية، نجدنا أمام فيلم «دعاء الكروان» والمأخوذ عن قصة طه حسين تحت نفس الاسم، ففي حين انتهى الفيلم إلى ما يمكن تسميته بنهاية عادلة أو شاعرية تنجي الأبطال من المأزق المصيري الذي انتهت إليه الأحداث، بعد أن أحبت آمنة المهندس الذي تسبب في وفاة أختها وكان الكروان شاهدًا على الجريمة. قتل المهندس بيد خال آمنة الذي قصد أن يرديها إلى مصير أختها بعد أن طالتها الإشاعات ببيت الرجل العازب. لفظ الحبيب أنفاسه وهو يمنح حياته فداء لذنبه عسى أن تغفر له الحبيبة.
في حين تغيرت النهاية عن الرواية الأصلية، التي تعلم فيها المهندس درسه من طول معاندة آمنة وتمسكها بكرامتها ورغبتها في الانتقام التي جهلها في البداية تمامًا، وارتحل الاثنين إلى بيت والديه حيث طلب المهندس منها قرب نهاية الرواية أن توافق على زواجه منها، وبعد طول رفض أرغمها على مصارحته بالسبب، وقد رد في النهاية على اتهامها بأنه وإن كان يخجل من ذنبه فلا سبيل إلى معاندة المصير، وطلب منها أن توافق على طلبه ليتزوجا ويعينا بعضهما بعضًا على التخلص من هذا الذنب والتكفير عنه.
تنتهي الرواية بنهاية مفتوحة إذ يرى طه حسين أن الجميع في هذا الموقف ضحايا والإنسان لا يكون شريرًا بل خطَّاء.
أتى الفيلم بعد ربع قرن تقريبًا من كتابة الرواية، وتحكي الأخبار أن فاتن حمامة هي من طلبت تغيير النهاية تماشيًا مع الذوق العام لجمهور السينما آنذاك وخط أدوار حمامة نفسها، التي علمت أن الجمهور لن يغفر لها النهاية الأصلية، والفارق هنا أن نعلم أن دكتور طه حسين قد رفض في البداية، بل واشترط أن تصور النهايتين على أن يعرضا عليه ليختار الأنسب.
أما فيما يخص موضوعنا عن تغييرات القصة والسيناريو، فنعلم أن طه حسين رفض في البداية تحويل الرواية إلى فيلم من الأساس، مصرحًا بأن: «الرواية تعتمد على الحوار، لست خبيرًا جدًا في رسم الصور التي هي أساس العالم السينمائي»، وهنا أتى دور السيناريست يوسف جوهر الذي أبدع في نقل الرواية على حالها المذكور إلى الشكل البديع التي ظهرت عليه في السينما.
في النهاية لسنا هنا بصدد المقارنة بحال، وإنما رغبة في إيضاح مبدأ أو قاعدة مهمة للغاية في ضرورة تحويل النصوص الأدبية إلى صورة سينمائية أو درامية، فالمجال مفتوح والإبداع لا يتوقف عند النسخة الأصلية وإن فعلت.. فغير ما يلزم.